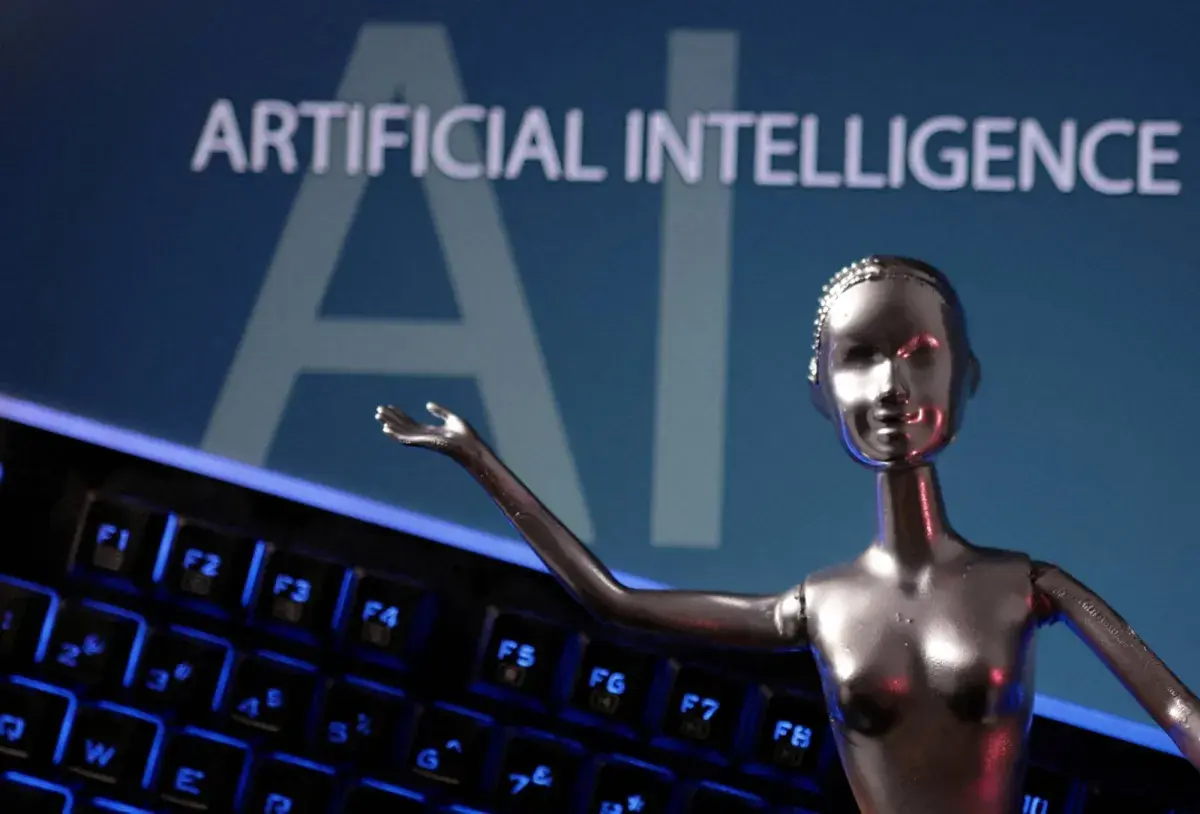حين تختار الدول تحويل أولوياتها من الاستثمار المدني إلى الأمن العسكري، فهي لا تعيد ترتيب موازناتها فحسب، بل تعيد رسم خريطة تخصيص الموارد على مستوى العالم. فالإنفاق العسكري بطبيعته لا يضيف طاقة إنتاجية مدنية، بل يسحبها من قطاعات النمو الطويلة الأجل، ويغير اتجاه تدفقات رأس المال، والمواد الخام، والتكنولوجيا.
بينما ترفع أوروبا وكندا إنفاقهما العسكري إلى مستويات غير مسبوقة يجد البنك الفيدرالي الأميركي نفسه أمام حال اقتصادية وصفها بـ"النادرة" أجبرته على خفض الفائدة على رغم استمرار التضخم. هذا التزامن لا يعكس مسارين منفصلين، بل يعكس تحولاً هيكلياً في الاقتصاد العالمي ستكون له تداعيات مباشرة على دول الخليج وأسواق الطاقة والمال.
يشهد الاقتصاد العالمي لحظة استثنائية لا تقاس بالأرقام وحدها، بل بما تحمله من اختلال عميق في الإيقاع بين الأمن والمال. ففي وقت تعود فيه أوروبا وكندا إلى رفع الإنفاق العسكري وتوسيع الجيوش الاحتياطية وكأنهما تستحضران ذاكرة عالم ظن أنه تجاوز منطق التسلح، يخرج البنك الفيدرالي الأميركي ليصف الواقع الاقتصادي بأنه "حال نادرة" اضطرته إلى خفض أسعار الفائدة على رغم استمرار الضغوط التضخمية.
هذا التزامن ليس مصادفة تاريخية، بل إشارة واضحة إلى دخول العالم مرحلة جديدة تعاد فيها صياغة العلاقة بين الأمن والاقتصاد. فحين يعلو صوت السلاح لا تبقى المعادلات المالية على حالها، وحين تعاد هندسة الأولويات الدفاعية تتغير تلقائياً خرائط الموارد، وأسعار الطاقة، ومسارات التضخم، وتجد السياسة النقدية نفسها أمام واقع لم تصمم أدواتها للتعامل معه.
ما يحدث اليوم ليس مجرد تحول دفاعي في الغرب أو ارتباك نقدي في الولايات المتحدة، بل بداية دورة اقتصادية عالمية مختلفة، تتداخل فيها الجغرافيا السياسية مع أسواق المال، وتختبر فيها قدرة الاقتصادات ومن بينها دول الخليج على قراءة التحول قبل أن تفرضه المؤشرات والأرقام.
في هذا السياق، لا يقرأ التوسع الدفاعي الأوروبي الكندي بوصفه تطوراً أمنياً فحسب، بل كمؤشر إلى الانتقال إلى مرحلة "اقتصاد الطوارئ الدفاعي"، وهو اقتصاد يعيد تشكيل طريقة تخصيص الموارد، وهيكلة الموازنات العامة، وديناميكيات الأسواق العالمية.
يتزامن هذا التحول مع تحذيرات لافتة من البنك الفيدرالي الأميركي بأن الاقتصاد يعيش "حالاً نادرة" دفعته إلى خفض أسعار الفائدة على رغم استمرار الضغوط التضخمية. هذه المفارقة: توسع مالي دفاعي في الغرب مقابل تيسير نقدي اضطراري في الولايات المتحدة، تعكس لحظة اقتصادية وجيوسياسية دقيقة لا يمكن قراءتها بمعزل عن بعضها بعضاً، وتتطلب فهماً أعمق لآثارها العالمية والإقليمية.
قد تبدو هذه المسارات منفصلة، غير أن قراءة دقيقة تكشف أنها جزء من منظومة واحدة يعاد تشكيلها اليوم. فمع إعادة توجيه هذا الحجم من الموارد نحو الصناعات الدفاعية، تبدأ الضغوط التضخمية بالتشكل، لا نتيجة فائض الطلب الاستهلاكي، بل بسبب ندرة المدخلات الإنتاجية نفسها. وهو نمط تضخم يصعب على أدوات السياسة النقدية التقليدية احتواؤه، لأنه ناتج من اختلال في جانب العرض لا في الطلب.
القرار الأوروبي - الكندي برفع الإنفاق العسكري، في هذا الإطار، لا يضيف أعباءً على الموازنات العامة فحسب، بل يخلق ضغطاً مالياً هيكلياً على النظام الاقتصادي العالمي. فهو يضغط على سلاسل الإمداد، ويرفع الطلب على التكنولوجيا والصناعات الاستراتيجية، وقد يولد موجات تضخمية في قطاعات المعادن، والطاقة، والخدمات اللوجيستية، وهي القطاعات التي تحدد المسار العام للتضخم العالمي.
وينتج من هذا التوجه ثلاث نتائج اقتصادية مباشرة:
أولها، ارتفاع كلف الإنتاج عالمياً نتيجة زيادة الطلب على المدخلات الإنتاجية، مما يعيد تنشيط حلقات تضخمية قطاعية.
ثانيها، تقييد القدرات الصناعية المدنية نتيجة تحويل الموارد من القطاعات المنتجة للنمو طويل الأجل إلى الصناعات الدفاعية.
وثالثها، زيادة العجز المالي لتمويل موجات الإنفاق العسكري، مما يضغط على أسواق السندات ويرفع كلفة الاقتراض عالمياً.
هذه النتائج لا تبقى داخل حدود أوروبا وكندا، بل تخلق موجات ارتدادية تضرب سلاسل الإمداد والأسواق الدولية، وتتفاعل مباشرة مع السياسة النقدية الأميركية. فعندما تتغذى الضغوط التضخمية من صدمات خارجية لا يملك الاقتصاد الأميركي السيطرة عليها تصبح السياسة النقدية أمام معادلة معقدة. فرفع أسعار الفائدة لا يخفض كلف الطاقة أو المعادن، لكنه يضغط في المقابل على النمو وسوق العمل.
في هذا السياق يجد الفيدرالي الأميركي نفسه مضطراً إلى خفض الفائدة لدعم اقتصاد يتباطأ، على رغم أن التضخم لم ينخفض بعد إلى مستويات الأمان. ومن هنا، فإن "الحالة النادرة" لا تعكس ضعفاً في القرار النقدي، بقدر ما تعبر عن لحظة تفقد فيها السياسة النقدية قدرتها على الفصل بين محاربة التضخم ومنع الركود، وهي حال لا تظهر إلا عندما تتداخل الصدمات الجيوسياسية مع بنية الاقتصاد العالمي.
بالنسبة إلى دول الخليج ينتقل أثر هذا الاختلال بسرعة أكبر بحكم ارتباط العملات المحلية بالدولار، ومركزية الطاقة في اقتصادات المنطقة. فارتفاع الإنفاق العسكري يعزز الطلب على الطاقة والمعادن الاستراتيجية، مما قد يبقي أسعار النفط في مستويات داعمة للموازنات العامة. غير أن تذبذب الاقتصاد الأميركي بوصفه أكبر مستهلك عالمي قد يخلق تقلبات حادة في الطلب ويؤثر في استقراره.
إلى جانب ذلك، فإن ارتفاع كلفة المواد الخام والآلات وسلاسل الإمداد نتيجة التحول الدفاعي الأوروبي قد يرفع الكلفة الرأسمالية للمشاريع الكبرى في الخليج، خصوصاً في قطاعات البتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة. وفي المقابل، يمنح هذا الموقع دول الخليج هامش مناورة استراتيجياً في مرحلة تتآكل فيها خيارات عديد من الاقتصادات الكبرى.
بهذا المعنى، فإن رفع الإنفاق العسكري في الغرب وتسييل السياسة النقدية في الولايات المتحدة ليسا حدثين متوازيين، بل هما مساران متقاطعان يصنعان دورة اقتصادية عالمية جديدة تتسم بارتفاع كلفة الأمن وتراجع يقين الأسواق.
وأمام هذا التحول يحتاج صانع القرار الخليجي إلى سياسات أكثر صرامة وتنبؤية تقوم على نماذج مالية ديناميكية مرتبطة بحال "الاقتصاد النادر"، وبناء هوامش أمان أعلى في الإنفاق العام، وتطوير أدوات فعالة للتحوط المالي. ولا يعني ذلك تغيير الارتباط بالدولار، بل استحداث آليات أدق لمراقبة تقلباته، وتطوير أدوات دين محلية تقلل من أخطار انتقال السياسة النقدية الأميركية.
Loading ads...
في عالم يتحرك في اتجاهين متعاكسين، تعلو فيه كلفة الأمن ويتراجع فيه يقين الاقتصاد، تصبح القدرة على الوقوف في المسافة الفاصلة من دون فقدان التوازن هي جوهر القوة الاقتصادية. فاعتبار ما يحدث تحولاً نادراً ليس توصيفاً اقتصادياً فحسب، بل إشارة واضحة إلى أن قواعد اللعبة العالمية بدأت تتغير بالفعل.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً