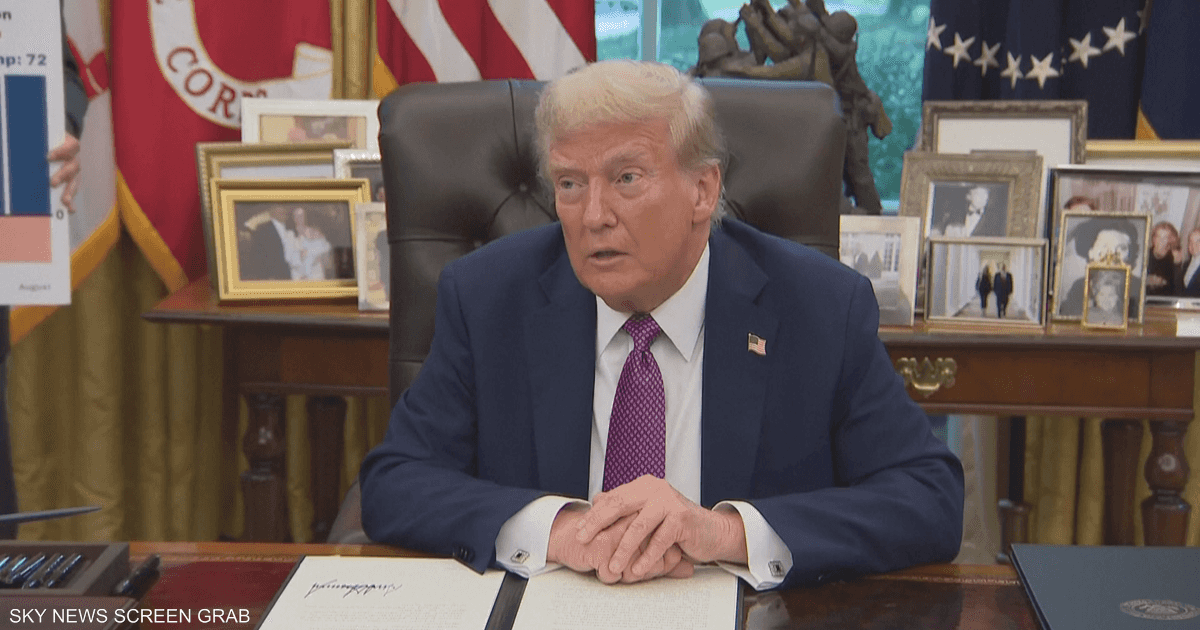في السادس من يناير/كانون الثاني 1941، اعتلى الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت منبر الكونغرس في لحظة فارقة من التاريخ العالمي، إذ كان العالم يشتعل بنيران الحرب العالمية الثانية، في حين تقف الولايات المتحدة على عتبة الدخول المباشر في أتونها. هناك، أعلن ما سُمّي لاحقاً بـ "الحريات الأربع": حرية الرأي والتعبير، وحرية العبادة، والتحرر من الحاجة، والتحرر من الخوف.
لم يكن روزفلت يوجّه خطابه للأميركيين وحدهم، بل للعالم بأسره. لقد أرادت واشنطن حينها أن تضع " أو تمنح بتعبير أكثر دقة" للبشرية خارطة طريق نحو نظام دولي جديد يتجاوز كارثة دمار القارة الأوروبية، ويواجه جاذبية الفاشية والنازية اللتين كانتا تقدّمان نفسيهما كنموذج بديل للحداثة. هذا الإعلان في جوهره كان تعبيراً عن طموح أخلاقي وسياسي معاً كما سوَّقته الولايات المتحدة حينها في قالب تحويل الحرب من صراع دموي على النفوذ إلى معركة من أجل الإنسان وكرامته.
حرية الرأي والتعبير في سوريا اليوم ليست مطلباً سياسياً فحسب، بل شرط وجودي لبناء مجتمع ما بعد الاستبداد.
الدافع وراء إعلان الحريات الأربع لم يكن إنسانياً صرفاً، بل سياسياً أيضاً. فقد أدرك روزفلت أن الانتصار على النازية لا يمكن أن يكون عسكرياً فقط، بل يحتاج إلى مشروع أخلاقي يقنع الشعوب بأن البديل أكثر عدلاً وإنسانية. لذلك قدّم الحريات الأربع كعقيدة مضادة للطغيان، وكسقف عالمي تتسع تحته تطلعات الشعوب المختلفة على اختلاف أديانها وقومياتها وعرقياتها وجغرافياتها بطبيعة الحال.
من هنا، لم تُقرأ كلمات روزفلت بوصفها خطاباً آنياً، بل كإطار فلسفي لمستقبل النظام الدولي. فقد أسّست هذه الرؤية، بعد سنوات قليلة، لما سيعرف لاحقاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر لعام 1948، وجعلت من الحريات الأربع حجر الأساس لفكرة أن السلام لا يُبنى على موازين القوى وحدها، بل على ضمان الحقوق الأساسية للبشر.
في التاريخ ثمة لحظات تُشبه المرآة، تكشف للإنسان صورته العميقة وتضعه أمام جوهر وجوده. في تلك اللحظات، يطلّ علينا مستويان متكاملان، متجاوران في بنيتهما، غير متطابقين في جوهرهما: حقوق الإنسان والحرية.
فالحقوق هي النبع الأول، الأصل الثابت الذي يولد مع الإنسان ولا يُستمد من دستور أومنظومة سياسية أوحاكم، بل من كينونته نفسها. إنها وديعة الوجود البشري، لا تنال منها قسوة القوانين ولا تُبطلها شراسة وأنياب الطغيان. من هنا، كان إعلان الاستقلال الأميركي عام 1776 وإعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا الذي أقرته الجمعية الوطنية عام 1789 لحظتين مفصليتين في تاريخ الإنسانية: ليس لأنهما ابتكرا الحقوق، بل لأنهما أعادا اكتشافها وأعلنا أن الإنسان يولد حاملاً إياها كما يولد محمّلاً بالكرامة.
غير أن الحقوق، مهما عُظمت نصوصها، تبقى صامتة إن لم تجد فضاءً سياسياً واجتماعياً تمارس فيه. وهنا يطلّ معنى الحرية، إنها ليست فكرة إضافية إلى الحق، بل فعل الممارسة الذي ينقل الحق من التنظير والتأطير إلى التجربة الحسية الملموسة، من الورق إلى الحياة. فالحق بلا حرية وعد مؤجَّل، والحرية بلا قانون يحميها انفعال عابر. وفي هذا المعنى فإن الحرية تمثِّل الجسر الذي يعبر عليه الحق ليبلغ واقعه الاجتماعي، وهي لحظة اكتمال المعنى الإنساني في التجربة الحية. ولعل العالم شهد هذا المعنى يتجلى بوضوح في وقت لاحق مع سقوط جدار برلين عام 1989، حين انقلبت الحقوق المكبوتة إلى فعل جماهيري كاسح، وكذلك في جنوب أفريقيا عام 1994، عندما تحولت المساواة من مبدأ أخلاقي إلى ممارسة سياسية أنهت نظام الفصل العنصري.
في التجربة السورية، إذا ما عدنا إلى خمسينيات القرن الماضي، فإن الدستور "الذي يحظى اليوم بتوافق غالبية السوريين" قدّم نصوصاً غنية بالحقوق أذكر منها: المساواة أمام القانون، حرية الاعتقاد، حرية الصحافة، وحق الاجتماع. غير أن قيمتها لم تكن في سطورها فحسب، بل في تلك اللحظة النادرة التي تحوّل فيها النص إلى ممارسة، فحضر تنافس الأحزاب في الانتخابات والتراشق السياسي، صحافة تكتب بجرأة، وبرلمان ينبض بالحياة. لقد كانت الحقوق مكتوبة، لكن الحرية هي التي جعلتها قابلة للعيش، ولو بحدود زمانها القصير الذي انتهى مع قيام ثورة البعث في الثامن من آذار لعام 1963.
في المثال السوري يتضح الفارق الدقيق والعميق معاً، فالحقوق هي الجوهر الكامن، والحرية هي انبثاق ذلك الجوهر في الفضاء العام. الحقوق تظل ثابتة في الفلسفة والنصوص، في حين الحرية هي الامتحان العملي لصدقيتها. ومن دون هذا التلازم يصبح الحق شعاراً معلقاً، وتتحول الحرية إلى اندفاعة بلا سند أو أرضية صلبة تضمن استمرارها. وحده التوازن بينهما هو الذي يمنح الشرعية معناها، ويعيد للكرامة الإنسانية مكانها.
السؤال الفلسفي والسياسي الذي يفرض نفسه على المشهد السوري بعد الثامن من ديسمبر 2024 بتقديري هو: كيف يمكن إعادة تأسيس الحريات في بلد خرج من الحرب مثقلاً بالخوف والجوع والانقسام؟ وفي الإجابة عن هذا الطرح لا يعتبر استدعاء خطاب روزفلت عن "الحريات الأربع" مجرد استعارة تاريخية، بل إطاراً لإعادة التفكير في معنى الدولة والإنسان بعد الكارثة. فحرية الرأي والتعبير في سوريا اليوم ليست مطلباً سياسياً فحسب، بل شرط وجودي لبناء مجتمع ما بعد الاستبداد. التجربة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية تعلّمنا أن الديمقراطية لا تُبنى بالانتخابات وحدها، بل بخلق فضاء عمومي، حيث يمكن للأفكار أن تتداول بحرية وتشكل أساساً للشرعية. في الفلسفة العربية، عبّر ابن رشد عن جوهر هذه الحرية حين رأى أن "إعمال العقل فريضة"، أي أن تقييد الفكر هو تقييد للوجود الإنساني نفسه. ومن هنا يصبح إصلاح القوانين لكل مستوياتها وضمان حماية المجتمع المدني ليس مجرد تفاصيل إجرائية، بل شرطاً لبعث الحياة السياسية من جديد. وفي البند الثاني من خطاب روزفلت يظهر عنوان حرية العبادة، والمسألة في سوريا اليوم ليس أن تُفتح أبواب المساجد والكنائس، فهذا قائم بحكم العادة والتاريخ، بل أن تتحرر العبادة وطقوسها من كونها أداة للتقسيم السياسي. هنا نستحضر مفهوم الحرية السلبية كما تم التنظير له في العلوم الاجتماعية، أي أن لا يتدخل أحد في خيارات الفرد الدينية، ولكن المطلوب أيضاً حرية إيجابية، أي أن يشعر الفرد أن انتماءه الديني لا يحد من مواطنته ولا يجعله مواطناً من درجة ثانية. ولوضع هذا المسار قيد التنفيذ أمامنا التجربة الأوروبية بعد الحروب الطاحنة التي أفضت إلى الدولة المدنية التي تفصل الدين عن السلطة دون أن تلغيه من حياة الناس. هذا بالضبط ما يحتاجه السوريون: دينٌ محرَّر من السياسة، ودولة محايدة تحمي جميع مواطنيها، هذا لا يتم بالكلام بل يحتاج قوانين ناظمة تحمي هذه المبدأية وترسخها، والتجربة التركية أمامنا لفهم المقصود.
إن سوريا، إذا ما استوعبت لحظتها التاريخية بعد سقوط الاستبداد وانكسار الحرب، تملك فرصة نادرة لتعيد تعريف موقعها ودورها، لا في الإقليم فحسب بل في التجربة الإنسانية جمعاء.
لا يمكن لسوريا أن تستعيد معنى الحرية إذا بقي مواطنوها تحت خط الفقر. روزفلت عبر مبدأ التحرر من الحاجة أدرك مبكراً أن الديمقراطية لا تزدهر في ظل الجوع، فربط الحرية بالعدالة الاجتماعية. في الفلسفة العربية، شدّد الفارابي على أن "المدينة الفاضلة" لا تقوم إلا حين تتوفر للإنسان حاجاته الأساسية بما يحفظ كرامته. انهيار الليرة السورية، مخلَّفات منظومة الفساد، وانعدام الخدمات تجعل من الإصلاح الاقتصادي وإعادة الإعمار ليس مجرد ملفات تقنية، بل جوهر السياسة نفسها. فالحرية السياسية بلا أساس اقتصادي عادل تتحول إلى وهم. يحضرني هنا ما ردده أبو ذر الغفاري "إذا ذهب الفقر إلى مكان قال له الكفر خذني معك".
لتحقيق الركائز السابقة لا بد من الإيمان يقينا بفكرة التحرر من الخوف، فالخوف هو العصب الذي سيطر به نظام الأسد الساقط على المجتمع لعقود، ثم أعادت جولات الحرب إنتاجه بأشكال جديدة. خوف من الغد، من غياب الأمن، من الجوع، ومن المجهول. هنا يظهر بُعد الحرية الإيجابية، أي أن يملك الفرد القدرة على أن يكون سيد قراره، لا مجرد كائن يتفادى الرعب. هذا يفرض إصلاحاً أمنياً عميقاً، استقلالاً للقضاء، وعدالة انتقالية لا تنزلق إلى الانتقام بل تؤسس للمصالحة. الفلسفة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية ربطت معنى الحرية بالتحرر من الخوف الجماعي، أي القدرة على الفعل السياسي من دون تهديد مستمر.
يمكن القول إن سوريا، إذا ما استوعبت لحظتها التاريخية بعد سقوط الاستبداد وانكسار الحرب، تملك فرصة نادرة لتعيد تعريف موقعها ودورها، لا في الإقليم فحسب بل في التجربة الإنسانية جمعاء. والتقاط هذه اللحظة التاريخية يضع البلاد على أعتاب إمكانية تحول استثنائي من ركام حرب طويلة إلى منارة إنسانية تضيء للعالم معنى متجدداً لمفهوم الحرية والحق. فالحريات الأربع ليست ترفاً خطابياً، بل مشروعاً تأسيسياً لإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع، بين السلطة والشرعية، بين الذاكرة الوطنية وآفاق المستقبل.
في هذا السياق، لا تكفي الحرية بوصفها رفعاً للقيود السلبية، بل تصبح حريةً إيجابية تؤسس لفضاء المشاركة والفعل والإبداع، حيث يخرج الفرد من موقع الضحية إلى موقع الفاعل في التاريخ. ومن هنا يكتسب المشروع السوري بعده الكوني: فهو يطرح إمكانية تحويل الأنقاض إلى طاقة نهضوية، والجراح إلى مختبرٍ لتجربة سياسية وأخلاقية جديدة.
وإذا ما تلاقت الإرادة السياسية مع الإرادة الاجتماعية، فإن سوريا قادرة على أن تقدم نموذجاً يتجاوز حدودها، نموذجاً يعيد إلى العالم الثقة بأن التحولات الكبرى ممكنة، وأن الخراب ليس قدراً محتوماً بل يمكن أن يكون منطلقاً لعصرٍ جديد. بهذا المعنى، قد تصبح سوريا شاهداً على أن الحرية ليست وعداً مؤجلاً، بل واقعاً يُصاغ بالإرادة، وأن أمةً مثخنة بالمآسي تستطيع أن تتحول إلى منارة للتاريخ الإنساني بأسره.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً